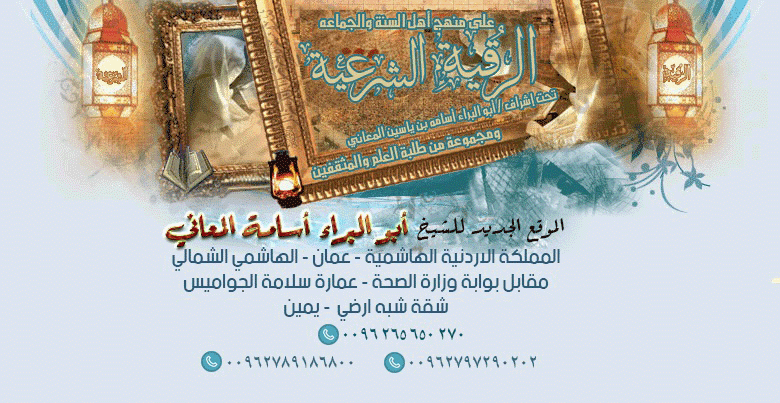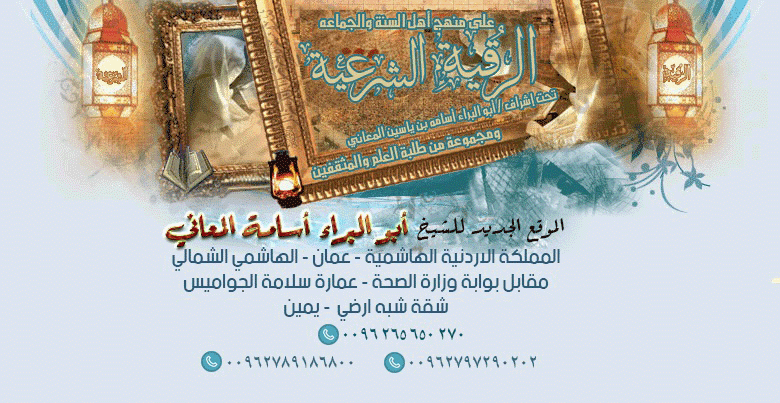س : ما الفرق الفرق بين أقوال القلب وأعماله ؟
ج : الفرق هو : أن أقوال القلب هي العقائد التي يعتبر فها ويعتقدها ، وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله، وهي محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه ، وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان . ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان .
س : اذكر اختلاف الفرق في تعريف الإيمان ؟
ج : أقوال الناس في تعريف الإيمان :
1 ـ عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة : أنه اعتقاد بالقلب ، ونطق باللسان ، وعمل بالأركان .
2 ـ عند المرجئة : أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط .
3 ـ عند الكرامية : أنه نطق باللسان فقط .
4 ـ عند الجبرية : أنه الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب .
س : وهل قول المعتزلة موافق تمام الاتفاق لقول أهل السنة في هذه المسألة ؟
ج : لا ، والفرق بينهم - أي : المعتزلة وبين أهل السنة - أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها . والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة .
س : هل الإيمان يزيد وينقص ؟
ج : نعم ، بل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان فتزيده الطاعة وينقص بالمعصية .
س : اذكر دليلاً يفيد أن الإيمان يزيد وينقص ؟
ج : يدل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى : ** إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ** ، وقوله تعالى : ** لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ** وغير ذلك من الأدلة .
س : وما موقف أهل السنة مع ناقصي الإيمان والأعمال من أصحاب المعاصي والكبائر ؟
ج : أهل السنة والجماعة - مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - هم مع ذلك - لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة لمجرد ارتكابه المعاصي التي هي دون الشرك والكفر ( كما يفعله الخوارج ) حيث قالوا : من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها !
س : ما هو وجه استدلال المؤلف بقوله تعالى ** فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأداء إليه بإحسان ** في هذا الفصل ؟ وما معنى قوله تعالى ** فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ** ؟
ج : 1 – استدل بالآية على أن سبحانه سمى القاتل أخًا للمقتول مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب ومع هذا لم تَزُل معه الأخوة الإيمانية .
2 – ومعنى الآية : أن الجاني إذا عفا عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص ورضي بأخذ المال في الدية فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف، وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطله .
س : وكذلك ذكر المؤلف قوله تعالى : ** وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ** وقوله ** إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحوُا بَينَ أخَوَيكُم ** فما هو وجه استدلاله بهاتين الآيتين الكريمتين ؟
ج : الاستدلال من الآيتين الكريمتين أنه سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والبغي بينهم، وسماهم إخوة للمؤمنين بقوله : ** فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ** ، وقال . وقوله تعالى : ** إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ** بمعنى : إنهم يرجعون إلى أمر واحد هو الإيمان فهم إخوة في الدين .
س : بين المعنى الإجمالي لقوله تعالى في الآية الكريمة ** وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ** ؟
ج : معنى الآية إجمالاً :
1 - أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله .
2 - فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه .
3 - فإن رجعت تلك الطائفة عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم، ويتحرروا الصواب المطابق لحكم الله، ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى ، آمراً سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين فقال : ** وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ** أي : اعدلوا إن الله يحب العادلين .
س : ما علاقة قوله تعالى : ** إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأصلحوا بين أخويكم ** بالآية التي سبقتها ؟ ولماذا قيل ** أخويكم ** بصيغة التثنية ؟
ج : قوله تعالى ** إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ** جملة مستأنفة مُقَرِّرَةٌ لما قبلها من الأمر بالإصلاح . والمعنى : إنهم يرجعون إلى أمر واحد هو الإيمان فهم إخوة في الدين ** فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ** يعني : كل مسلمين تخاصمًا وتقاتلًا .
وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى .
س : ما هو الفرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق ؟
ج : الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل . ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص .
س : هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق أو في مطلق الإيمان ( مع الدليل ) ؟
ج : في المسألة تفصيل كالتالي :
1 - الفاسق [ قد ] يدخل في اسم ( الإيمان المطلق ) [ إذا قُصِد به الإيمان ] الذي يشمل الإيمان الكامل والإيمان الناقص كما في قوله : ** فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ** ؛ فإنَّ من أعتق فاسقًا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة، ككفارة الظهار والقتل، أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء .
2 - قد لا يدخل في اسم ( الإيمان المطلق ) أي : إذا أريد بالإيمان الكامل :
أ – كما قوله تعالى : ** إِنَّمَا[1]الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تُليت عليهم آياته[2] زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون[3]** لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية الكريمة الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص .
ب - و قوله r : ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة[4]ذات شرف[5]يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن ... )) أي : كامل الإيمان فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان .
س : في الحديث السابق الوارد في فقرة ( ب ) ما هو الدليل على أن المنفي هو الإيمان كمال الإيمان وليس جميع الإيمان ؟
ج : بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر ، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك ، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب .
س : ذكر المؤلف رحمه الله خلاصة هذا الفصل ونتيجته وضح ذلك ؟
ج : نعم ، ذكر ذلك بقوله في حق الفاسق الملي : ( ونقول : هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ) وهذا هو الحكم العادل جمعًا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كحديث : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) والنصوص التي أثبتت الإيمان له، كآية القصاص وآية حكم البغاة السابقتين .
[1]** إِنَّمَا ** : أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه
[2]** آيَاتُهُ ** أي : قرئت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية .
[3]** زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ** أي : زاد إيمانهم بسبب ذلك ** وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ** أي : يفوضون جميع أمورهم إليه لا إلى غيره .
[4]النهبة بضم النون : هي الشيء المنهوب، والنهب : أخذ المال بالغلبة والقهر
[5]( ذات شرف ) أي : قدر . وقيل : ذات استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم .